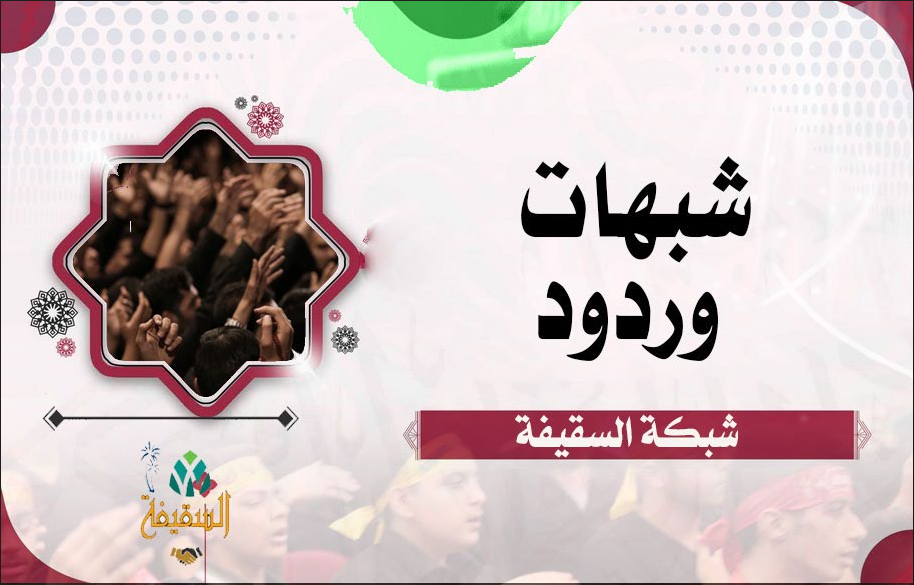من أخطر مظاهر الاضطراب المنهجي في الفقه الشيعي الإمامي ما آل إليه أمر الخمس، لا من حيث أصل مشروعيته فحسب، بل من حيث حصر التصرف في جميع موارده بيد الفقيه، لا في سهم الإمام وحده كما زُعم في المراحل الأولى، بل في السهمين جميعًا، حتى صار الخمس مؤسسة مالية مغلقة، لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن المرجع أو الولي الفقيه.
وقد لمّح كبار فقهاء الشيعة المتقدمين والمتأخرين إلى هذا المسار قبل أن يصرّحوا به صراحة، فمهدوا له بعبارات الاحتياط، ثم حوّلوه إلى قاعدة فقهية ملزمة، ثم إلى حصرٍ كاملٍ يمنع عامة الشيعة – بل حتى السادة وطلبة العلم – من التصرف في الخمس، مهما بلغت الحاجة، إلا بعد الاستئذان الشخصي من المرجع الذي يُقلَّد.
وتكشف نصوص المجلسي، والسبزواري، وصاحب الجواهر، ثم الخميني ومن بعده، عن تطور خطير في الفهم الفقهي للخمس، حيث جُعل مالًا من أموال بيت الدولة الدينية، يتولى الفقيه وحده النظر فيه، والتصرف به، وتحديد مصارفه، ومنع غيره من الاقتراب منه، بزعم النيابة العامة عن الإمام الغائب. ثم لم يكتفوا بذلك، بل ربطوا صحة الإبراء من الذمة بتسليم الخمس إلى الفقيه أو وكيله، وحكموا ببطلان تصرفات المكلفين فيه ولو كانت في أوجه البر الظاهرة، كإغاثة الفقراء، وبناء المساجد، ومعالجة المرضى، ما لم تصدر بإذن خاص.
والمفارقة الصارخة أن هؤلاء أنفسهم استندوا في بداية الأمر إلى دعاوى العلم برضا الإمام الغائب، واستدرار العواطف بوصفه رؤوفًا بمواليه، كريمًا بعياله، ليجيزوا التصرف في سهمه زمن الغيبة، ثم انقلب هذا الرضا المزعوم إلى احتكار فقهي صارم، لا يعترف برضا الإمام إلا إذا مرّ عبر توقيع المرجع وختمه. فإذا تعلق الأمر بعامة الشيعة قيل لهم: الإمام راضٍ، وإذا تعلق الأمر بالأموال قيل: لا رضا بلا إذن الفقيه.
حصر التصرف في جميع موارد الخمس في الفقيه وليس سهم الإمام فحسب:
ولكن قبل ذلك نورد أقوالهم في حصر التصرف في جميع موارد الخمس في الفقيه وليس سهم الإمام فحسب، حيث مهدوا لهذا القول قبل قولهم بوجوب حصره في الفقيه أو المرجع أو الولي الحاكم (الولي الفقيه).
يقول المجلسي ملمحاً:
(وأكثر العلماء قد صرحوا بأن صاحب الخمس لو تولى دفع حصة الإمام عليه السلام لم تبرأ ذمته بل يجب عليه دفعها إلى الحاكم، وظني أن هذا الحكم جارٍ في جميع الخمس)[1].
ويقول السبزواري:
(الأحوط عندي صرف الجميع في الأصناف الموجودين بتولية الفقيه العدل الجامع لشرائط الإفتاء، وينبغي أن يراعى في ذلك البسط بحسب الإمكان ويكتفي بمقدار الحاجة ولا يزيد على مؤنة السنة، ويراعى الأعجز والأحوج والأرامل والضعفاء، والأولى أن يقسم النصف أقساماً ثلاثة يصرف كل ثلث في صنف من الأصناف الثلاثة. ونقل الشهيد الثاني إجماع القائلين بوجوب صرف حصة الإمام في الأصناف على أنه لو فرقه غير الحاكم، يعني: الفقيه العدل الإمامي، ضمن)[2].
ويقول الجواهري:
(لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في أن الخمس جميعه للإمام عليه السلام، وإن كان يجب عليه الاتفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله، ولذا لو زاد كان له عليه السلام، ولو نقص كان الاتمام عليه من نصيبه، وحللوا منه من أرادوا)[3].
ثم جاء الخميني وصرح قائلاً:
(وبالجملة من تدبر في مفاد الآية والروايات يظهر له أن الخمس بجميع سهامه من بيت المال، والوالي ولي التصرف فيه، ونظره متبع بحسب المصالح العامة للمسلمين، عليه إدارة معاش الطوائف الثلاث من السهم المقرر ارتزاقهم منه حسب ما يرى. كما أن أمر الزكوات بيده في عصره يجعل السهام في مصارفها حسب ما يرى من المصالح. هذا كله في السهمين. والظاهر أن الأنفال أيضاً لم تكن ملكاً لرسول الله والأئمة - صلوات الله عليهم أجمعين - بل لهم ملك التصرف، وبيانه يظهر مما تقدم)[4].
أدلة جواز التصرف في سهم الإمام في زمن الغيبة:
نعود إلى ذكر الأدلة التي قالوا بها على جواز التصرف في سهم الإمام في زمن الغيبة:
منها العلم برضا الإمام، ومن أقوالهم في هذا الباب والتي بها يمهدون للأمر مدغدين للعواطف، قول الجواهري: (لكن قد عرفت بحمد الله تعالى وضوح السبيل في مصرف حق غير الإمام، وإن اضطرب فيه من عرفت، وأما حقه عليه السلام فالذي يجول في الذهن، أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي لروحه الفداء يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة الذين هم عياله في الحقيقة، بل ولا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم مما يرجح على بعضها وإن كان هم أولى وأولى عند التساوي، أو عدم وضوح الرجحان، بل لا يبعد في النظر تعين صرفه فيما سمعت بعد البناء على عدم سقوطه، إذ غيره من الوصية به أو دفنه أو نحوهما تعريض لتلفه وإذهابه من غير فائدة قطعاً، بل هو إتلاف له)[5].
ويقول النراقي:
(فإنا نعلم قطعاً - بحيث لا يداخله شوب شك - أن الإمام الغائب - الذي هو صاحب الحق في حال غيبته، وعدم احتياجه، وعدم تمكن ذي الخمس من إيصاله حقه إليه، وكونه في معرض الضياع والتلف، بل كان هو المظنون، وكان مواليه وأولياؤه المتقون في غاية المسكنة والشدة والاحتياج والفاقة - راض بسد خلتهم ورفع حاجتهم من ماله وحقه. كيف؟! وهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فما الحال إذا لم تكن لهم حاجة وخصاصة؟! وكيف لا يرضى وهو خليفة الله في أرضه والمؤمنون عياله، كما صرح به في مرسلة حماد، وفيها: «وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له». وهو منبع الجود والكرم، سيما مع ما ورد منهم وتواتر من الترغيب إلى التصدق وإطعام المؤمن وكسوته والسعي في حاجته وتفريج كربته، والأمر بالاهتمام بأمور المسلمين، حتى قالوا: «من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم». وقالوا في حق المسلم على المسلم: «إن له سبع حقوق واجبات، إن ضيع منها شيئاً خرج من ولاية الله وطاعته، ولم يكن لله فيه من نصيب» إلى أن قال: «أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك» إلى أن قال: «والحق الثالث: أن تغنيه بنفسك ومالك» إلى أن قال: «والحق الخامس: أن لا تشبع ويجوع» الحديث. وجعلوا من حقوق المسلم: مواساته بالمال. ومع ذلك يدل عليه إطلاق رواية محمد بن يزيد ومرسلة الفقيه المتقدمتين، فإن إعطاء الخمس صلة. ولا يتوهم أن بمثل ذلك يمكن إثبات التحليل لذي الخمس أيضاً وإن لم يكن فقيراً، لأن أداء الخمس فريضة من فرائض الله، واجب من جانب الله، وإعطاؤه امتثال لأمر الله، وفيه إظهار لولايتهم وتعظيم لشأنهم وسد لحاجة مواليهم، ومنه تطهيرهم وتمحيص ذنوبهم. ومع ذلك ترى ما وصل إلينا من الأخبار المؤكدة في أدائه والتشدد عليه، وأن الله يسأل عنه يوم القيامة سؤالاً حثيثاً، وتراهم قد يقولون في الخمس: لا نجعل لأحد منكم في حل، وأمثال ذلك. ومع هذا لا يشهد الحال برضاه عليه السلام لصاحب المال أن لا يؤدي خمسه، فيجب عليه أداؤه لأوامر الخمس وإطلاقاته واستصحاب وجوبه، ومعه لم يبق إلا الحفظ بالدفن أو الوصية أو التقسيم بين الفقراء. والأولان مما لا دليل عليهما، فإن الدفن والإيداع نوعا تصرف في مال الغير لا يجوز إلا مع إذنه، ولا إذن هناك، بل يمكن استنباط عدم رضائه بهما من كونهما معرضين للتلف، ومن حاجة مواليه ورعيته.
فلم يبق إلا الثالث الذي علمنا رضاه به، فيتعين ويكون هو الواجب في نصفه. ولما كان المناط الإذن المعلوم بشاهد الحال والروايتين ونسبتهما إلى السادات وغيرهم من فقراء الشيعة على السواء، فيكون الحق هو المذهب الأخير، والأحوط اختيار السادة من بين الفقراء. ولكن قد يعكس الاحتياط، كما إذا كان هناك شيعة ولي ورع معيل في ضيق وشدة ولم يكن السادة بهذا المثابة. وعلى المعطي ملاحظة الأحوال)[6].
ويقول الأنصاري:
(إن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم، هو القطع برضائه عليه السلام بصرف حصته فيهم، ورفع اضطرارهم بها، وفيما يحتاجون إليه من الأمور العامة والخاصة، فالشك في هذا ليس إلا من جهة عدم إعطاء التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة، مضافاً إلى أنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضاه بالخصوص. مضافاً إلى أن الظاهر أن المناط فيما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالكهو تعذر الإيصال إلى مالكه لأجل الجهل، فالجهل لا مدخل له في أصل الحكم وإنما هو سبب للتعذر، فإذا حصل التعذر من وجه آخر مع العلم بالشخص وتعينه جاء الحكم أيضاً.
مضافاً إلى عموم ما دل على أنه «من لم يقدر على أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا» وخصوص رواية ابن طاوس في وصية النبي صلى الله عليه وآله مضافاً إلى ما يشعر به ما دل على وجوب صرف نذر هدي البيت في زواره، معللاً بأن الكعبة غنية عن ذلك وما جاء في صرف الوصية التي نسي مصرفها في وجوه البر، وكذا الوقف الذي جهل أربابه مضافاً إلى رواية الطبري عن الرضا عليه السلام من: «أن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته»، فصرف حقه عليه السلام في أيام غيبته في حوائج ذريته وشيعته، لا يخلو عن أحد المصارف المذكورة في الرواية.
فيجوز حينئذ صرف حصته عليه السلام من الخمس أو مال آخر مما يقع بأيدينا من أمواله عليه السلام في الذرية الطاهرة المحتاجين؛ لأن سد خلتهم كان أحد المصارف لأمواله بل كان من أهمها دفع حصته (ع) إلى الأصناف إتماماً للنقص، وقد استدل جماعة على وجوب دفع حصته في هذا الزمان إلى الأصناف من باب التتمة، لأن علية إتمام ما نقص[7].
والطريف أنهم وهم يقولون برضا المهدي على هذا التصرف، ولكن عندما تعلق الأمر بهم لم يقبلوا به.
سأل أحدهم: هل يكفي في مصرف سهم الإمام عليه السلام إحراز رضا الفقيه به أم لا بد من الاستيذان منه؟ وعلى الثاني هل تقوم الاستجازة بعد المصرف مقام الاستيذان أم لا؟
الخوئي: (لا بد من الاستيذان قبل المصرف، ولو صرف في مورده الشرعي من غير استيذان فالإجازة المتأخرة ترفع الضمان)[8].
والكلام في هذا الباب يطول.
ومن الأقوال أيضاً التي ذهب إليها من رأى جواز التصرف في سهم الإمام هو التصدق بها عن الإمام باعتبار أنها أموال مجهولة المالك.
يقول صاحب الجواهر:
(وأقوى من ذلك معاملته معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذر الوصول إليه روحي له الفداء، إذ معرفة الملك باسمه ونسبه دون شخصه لا تجدي، بل لعل حكمه حكم مجهول المالك باعتبار تعذر الوصول إليه للجهل به، فيتصدق به حينئذ نايب الغيبة عنه، ويكون ذلك وصولاً إليه على حسب غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابهما، والله أعلم بحقائق أحكامه)[9].
ومن أقوالهم الولاية على أموال الغائبين، وحيث أن الإمام غائب فإن الفقهاء يجوز لهم التصرف في أمواله.
سبحان الله! فعندما تعلق الأمر بالمال قالوا أنه غائب ووجوده كعدمه، ونسوا أنه حجة الله على خلقه. ولله في خلقه شؤون.
وغيرها من دلائل بنوا من خلالها على جواز بل وجوب التصرف بسهم الإمام في غيبته، ثم شرعوا في حصر هذا التصرف في الفقهاء.
يقول الشهيد الثاني: (إن سهم الإمام يصرف إليه إن كان حاضراً، أو إلى نوابه وهم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى، لأنهم وكلاؤه)[10].
[1] نقله عن المجلسي في كتابه زاد المعاد: يوسف البحراني في الحدائق الناضرة (17/486)،والجواهري في جواهر الكلام (16/187).
[2] كفاية الأحكام، للسبزواري (1/222).
[3] جواهر الكلام، للجواهري (16/155)، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، للمنتظري (3/120).
[4] كتاب البيع، للخميني (2/662)، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، للمنتظري (3/118).
[5] جواهر الكلام، للجواهري (16/177).
[6] مستند الشيعة، للنراقي (10/133).
[7] كتاب الخمس، للأنصاري (333)، كتاب الطهارة، للأنصاري (2/551).
[8] صراط النجاة، لميرزا جواد التبريزي (1/201).
[9] جواهر الكلام، للجواهري (16/177).
[10] شرح اللمعة، للشيهد الثاني (2/79).