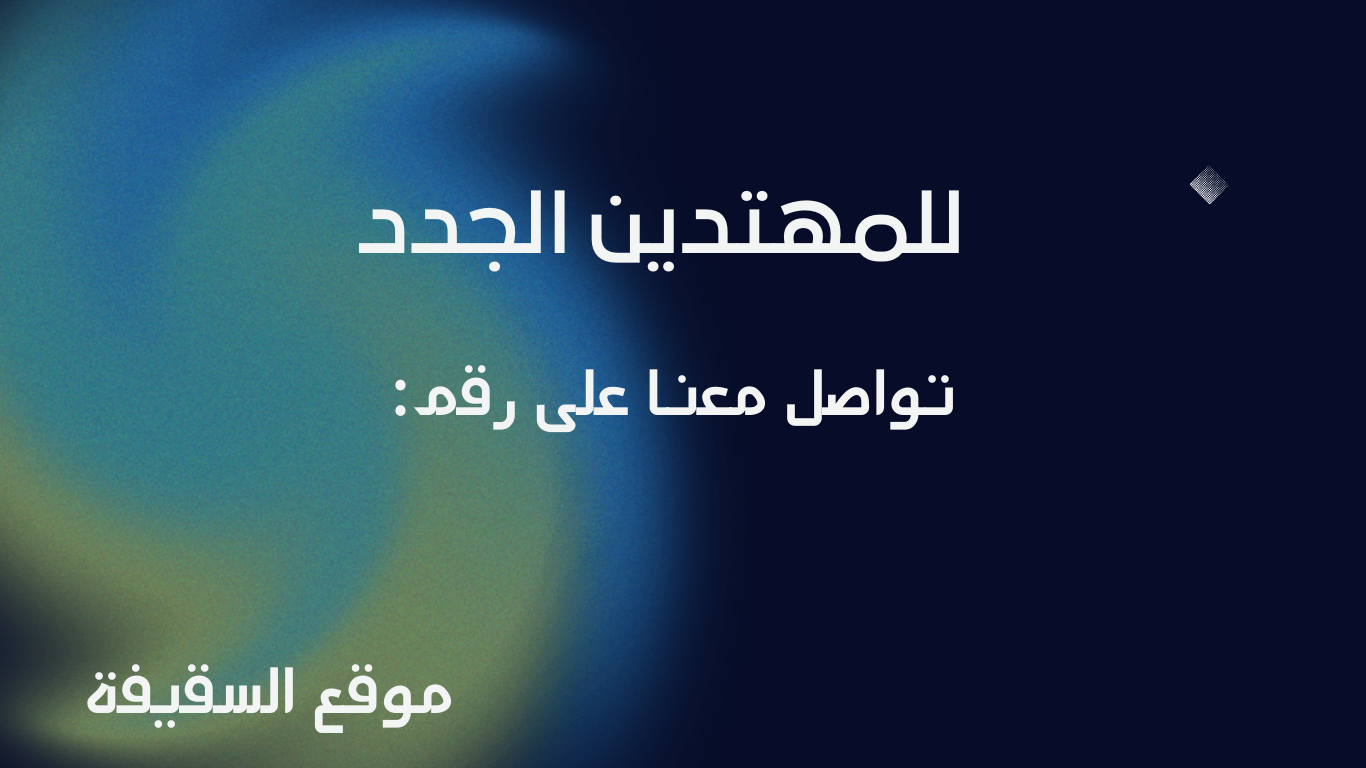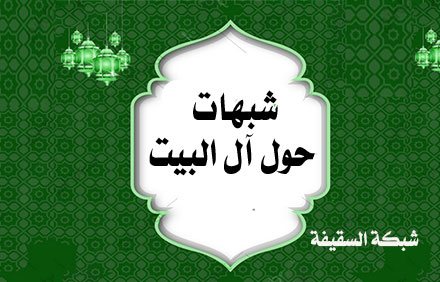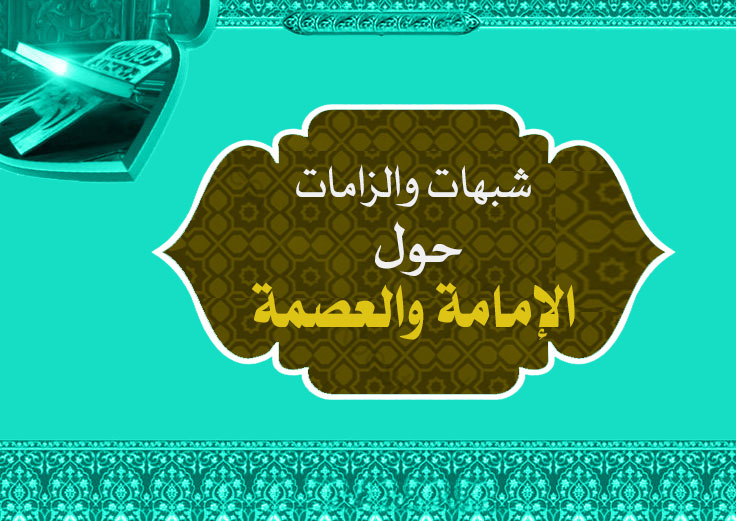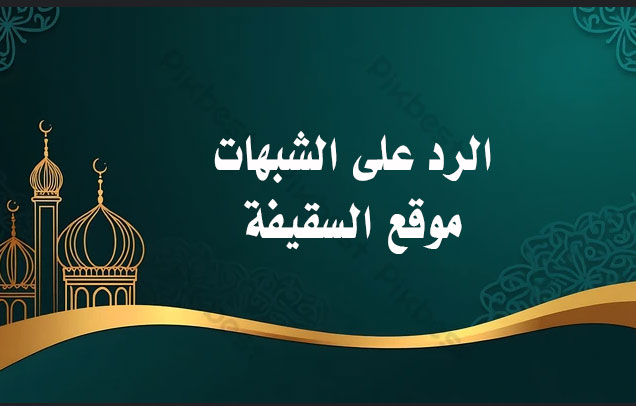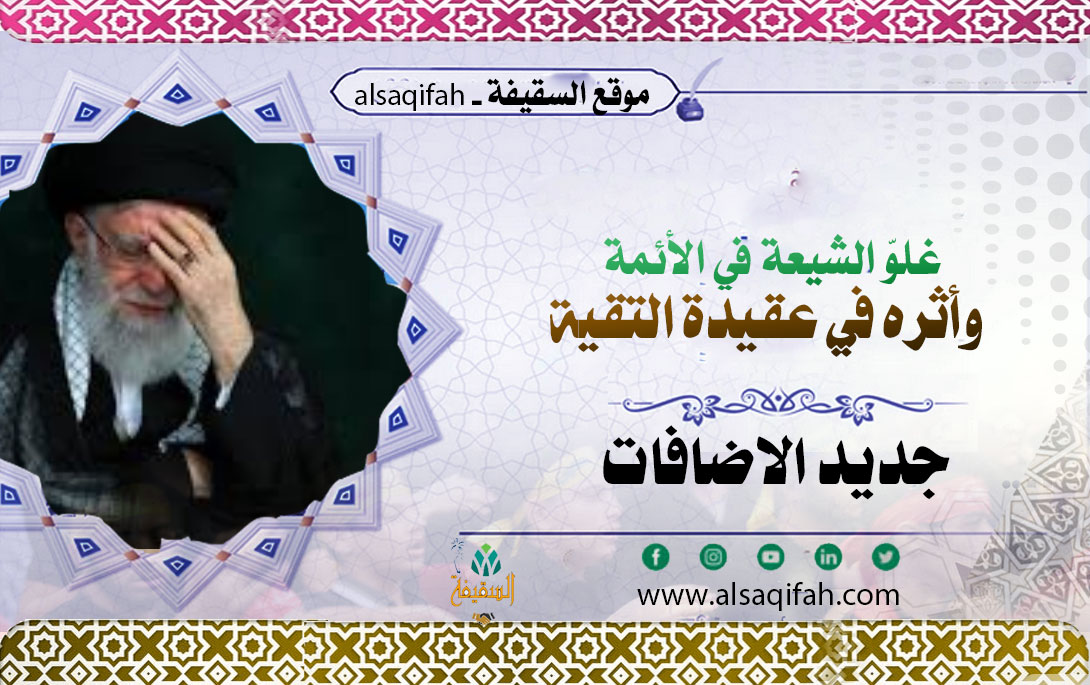من المعلوم في عقيدة المسلمين أن الأنبياء معصومون عن الكذب والجهل، وأنهم أهل علم وهداية لا يصدر عنهم إلا ما يُرضي الله تعالى. ومن الشبهات التي تُثار حول نبي الله نوح عليه السلام، ما ورد في قوله تعالى:
﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ * قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [هود: 45-46].
ويزعم بعض المتشككين أن في الآية تكذيبًا لقول نوح عليه السلام، بل ويستدلون بها على نسبة الجهل إليه، وهذا ما يتعارض مع أصل العصمة والنبوة. فكيف نُجيب عن هذه الشبهة؟ إليك تفصيل الجواب.
✦ الشبهة:
يقول الطاعن:
ظاهر الآية أن الله تعالى نفى كون ابن نوح من أهله، بينما نوح يقول: "إن ابني من أهلي"، فهل هذا يدل على أن نوح عليه السلام قال كلامًا باطلًا؟ وهل يُعقل أن نبيًا يقول ما لا يعلم؟!
✦ الجواب المفصل:
✅ الوجه الأول: نفي الأهلية لا يعني نفي النسب، بل نفي الاستحقاق للنجاة
نص الآية في قوله تعالى: ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ [هود: 40]، يدل على أن الوعد بالنجاة لأهل نوح مشروط بعدم سبق القول عليهم (أي: عدم سبق القضاء بهلاكهم).
فلما قال نوح: ﴿إن ابني من أهلي﴾، كان يتكلم باعتبار النسب الظاهري، ولكن الله عز وجل بيّن أن الوعد لم يشمل هذا الابن لأنه من المستثنين.
أي أن نفي الأهلية هنا ليس نفيًا للقرابة، بل نفيٌ للأهلية الدينية والإيمانية التي استوجب بها الهلاك.
✍️ قال ابن عباس: "إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم، لأنه كان منافقًا في الباطن، كافرًا في السر".
✅ الوجه الثاني: "ليس من أهلك" أي ليس من أهل دينك ولا على طريقتك
وهو تأويل أهل اللغة والبيان، حيث تُستعمل "الأهل" للدلالة على القرابة المعنوية، مثل أهل الإيمان والدين.
فمعنى الآية:
﴿إنه ليس من أهلك﴾: أي ليس على نهجك، وليس على دينك، فليس لك أن تطالبه بالنجاة.
ويؤكد هذا المعنى ما ورد بعده:
﴿إنه عمل غير صالح﴾، أي أن عمله (كفره ومخالفته) أخرجه من أهلية النجاة.
وهذا الوجه مروي عن الضحاك، وقتادة، والحسن البصري وغيرهم.
✅ الوجه الثالث: أنه لم يكن ابنه على الحقيقة (وجه مرجوح)
قال بعض المفسرين: إن ابن نوح لم يكن ابنًا له من صلبه، بل ولد على فراشه من زنا، فكان يُحسب ابنه بحسب الظاهر، فبين الله له خلاف ذلك.
لكن هذا القول مردود وضعيف، للأسباب التالية:
1- القرآن أطلق عليه "ابنه" صراحة في قوله: ﴿ونادى نوح ابنه﴾ [هود: 42].
2- استثناه الله من "أهلك" في قوله: ﴿إلا من سبق عليه القول﴾، مما يدل على دخوله في الأهل بالمعنى الظاهري.
3- الأنبياء منزهون عن مثل هذه المواقف التي تُسيء إليهم أو تنقص من شأنهم.
ولذا فإن القول بأنه "ابن غير شرعي" ليس صوابًا ولا هو من أدب التفسير.
✅ مناقشة تأويل "إنه عمل غير صالح"
هل الهاء في "إنه عمل غير صالح" تعود على السؤال أم على الابن؟
قيل: إن المقصود أن سؤالك غير لائق، لأنه طلب ما لا علم لك به.
لكن الأرجح أن الهاء تعود إلى الابن نفسه، أي: "إنه ذو عمل غير صالح"، بدليل:
سياق الآية: "إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح"، متسق في الحديث عن الابن.
ما ورد عن القراء الذين قرأوا الآية بـ"إنه عَمَلٌ" بفتح اللام، أي: عمله غير صالح.
أسلوب العرب: يُقيمون الوصف مقام الموصوف، كما في قولهم: "قال خيرًا"، أي: "قال قولًا خيرًا".
✅ قوله تعالى: ﴿فلا تسألن ما ليس لك به علم﴾
هذا نهي عن سؤال لا علم فيه، لا يعني أن نوح عليه السلام وقع في خطأ أو جهل، بل هو تنبيه ورحمة ووقاية، مثلما نُهي النبي محمد ﷺ عن الشرك وهو معصوم منه، كما في قوله تعالى:
﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: 65].
وقول نوح بعد ذلك: ﴿إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم﴾ هو توبة أدب وتعظيم لله، لا توبة عن معصية، بل تأدب في مقام الدعاء.
الخلاصة:
إن آيات قصة نوح وابنه لا تدل على جهل نوح عليه السلام، ولا على وقوعه في كذب أو خطأ، بل:
♦ تدل على علو منزلته عند الله، حيث أوقفه الله على حقيقة خفية.
♦ وتدل على أن النجاة ليست بالنسب بل بالإيمان.
♦ وتُظهر حرص الأنبياء على أقاربهم، مع تمام التسليم لحكم الله.
وقد أجمع العلماء أن الأنبياء منزهون عن الظلم، والكذب، والجهل، والسفاهة، والزنا، وكل ما ينفّر من دعوتهم، وبهذا تسقط الشبهة من أصلها.
مصادر للاستزادة:
♦ تفسير الطبري.
♦ تفسير ابن كثير.
♦ تفسير الرازي.
♦ تفسير القاضي عبد الجبار.
♦تفسير الزمخشري.
♦ دراسات إعجازية في عصمة الأنبياء.