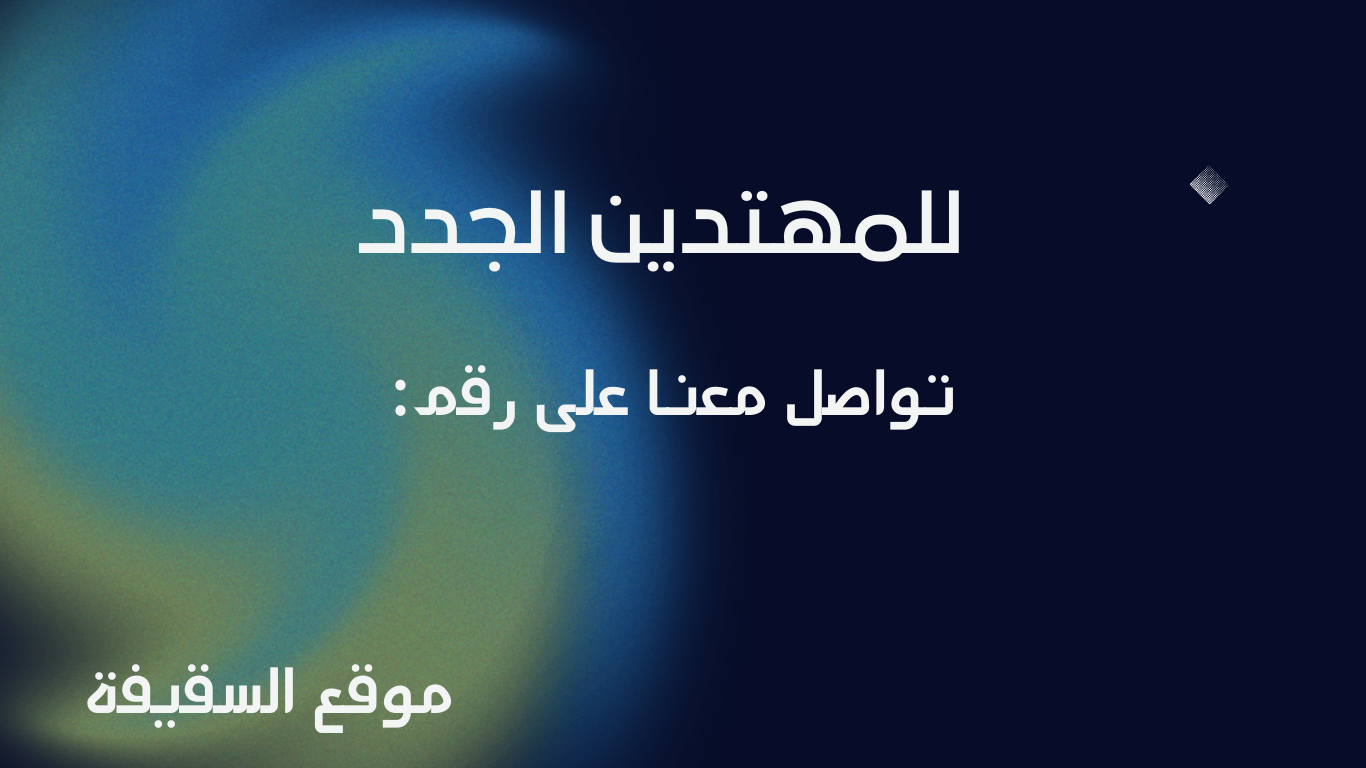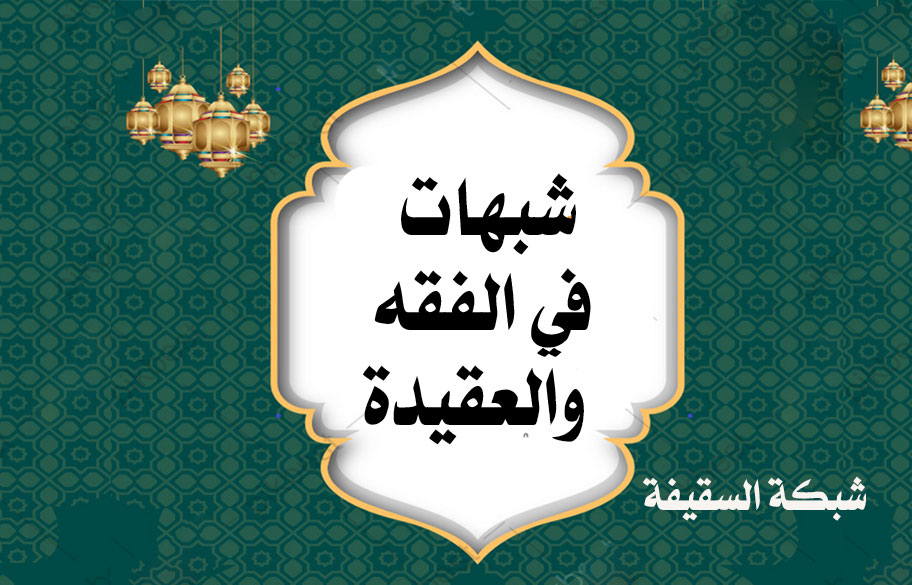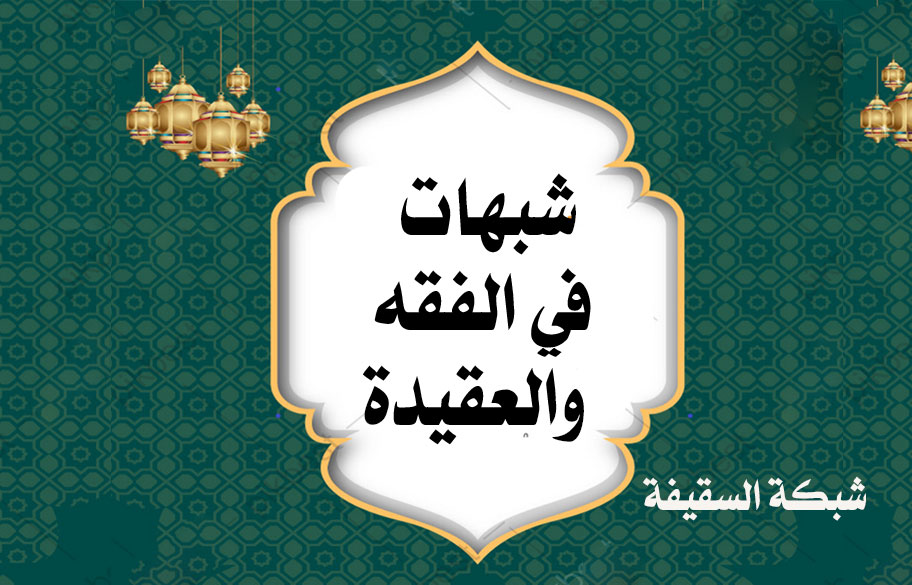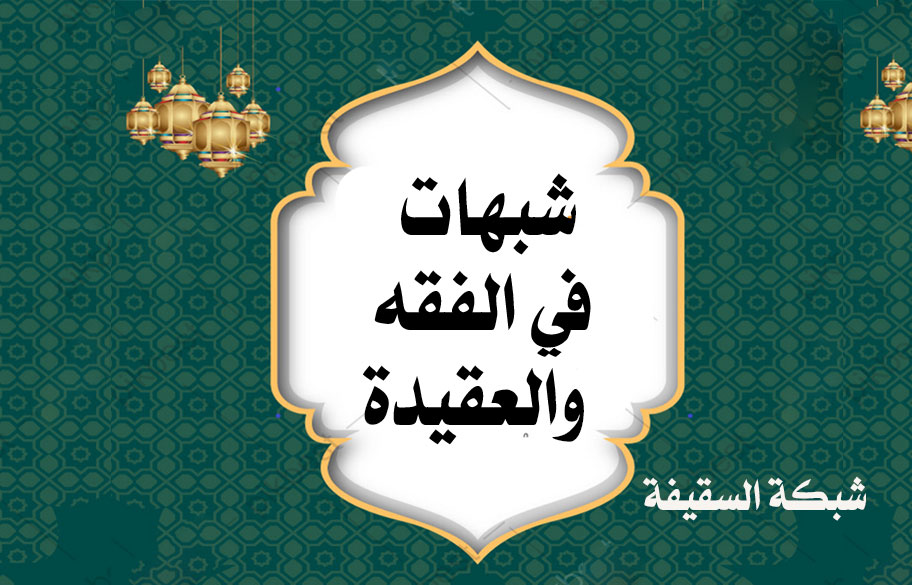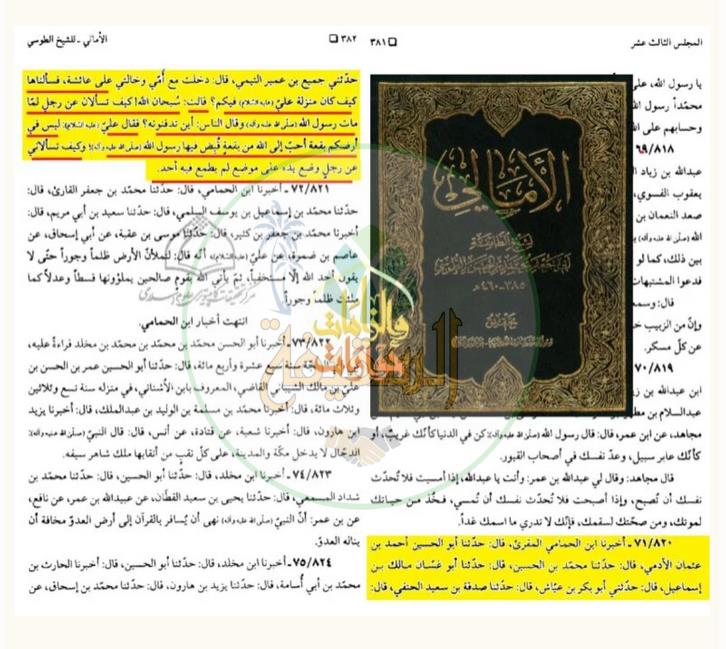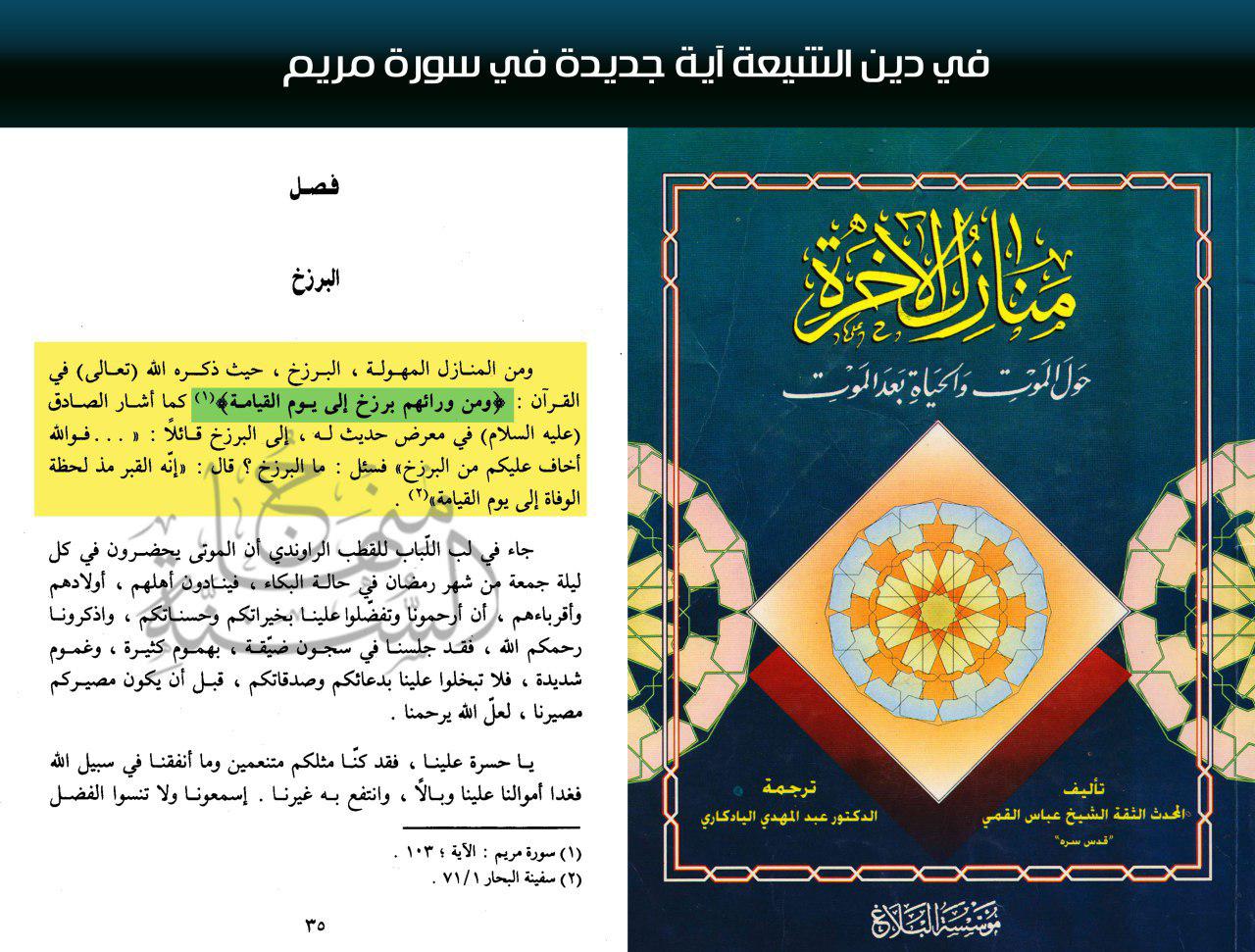لقد رسمت الشريعة الإسلامية معالم القيادة في الأمة الإسلامية، فبينت واجبات الإمام، ووظائفه، وأثره في إقامة الدين وحفظ النظام، لأن قيادة الأمة لا تستقيم إلا بشرطين:
قيام القائد بواجباته، وقيام الرعية بواجباتهم تجاهه.
وقد أسند الله هذه المهام أولًا للأنبياء صلوات الله عليهم، فهم قدوة القادة والمصلحين، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ [المائدة: 67].
ومن المهام الأساسية للإمام:
تعليم الناس الكتاب والحكمة، وتزكية النفوس، كما في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا ... يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [الجمعة: 2]، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ومواجهة أهل الباطل بالحجج.
ومن أعظم الواجبات على الإمام:
إقامة الجهاد، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: 60]، وإقامة الحدود، والحكم بين الناس بما أنزل الله، قال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: 49]، وقال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ... وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾ [ص: 26].
وقد أوجز الإمام الماوردي في كتابه "الأحكام السلطانية" عشرة من واجبات الإمام، منها:
حفظ الدين من التبديل والضياع، وتنفيذ الأحكام الشرعية، وحماية الثغور من الأعداء، وإقامة الحدود لردع المفسدين، وجباية الأموال الشرعية وصرفها في مصارفها، وتولية الأكفاء للمناصب، والإشراف على مصالح العامة، ومحاسبة المتجاوزين.
وقال الإمام الباقلاني:
من فرائض السلطان دون غيره:
إقامة الحدود، وقبض الصدقات، وتولية القضاة، والفصل بين المتخاصمين. وبيّن أن هذه الوظائف لا يجوز أن يتولاها أحد غير الإمام أو من يُنيبه، لما فيها من ضبط النظام وتحقيق العدل.
وقال ابن حزم: "الإمام إنما جُعل ليقيم الناس الصلاة، ويأخذ صدقاتهم، ويقيم حدودهم"، فوظيفة الإمام عند أهل السنة ليست دينية خالصة كما يتصور البعض، بل هي وظيفة دينية سياسية خدمية، تهدف إلى إقامة شرع الله في الأرض وضمان استقرار المجتمع.
وأشار الفقيه وهبة الزحيلي إلى أن من وظائف الإمام نصرة المظلوم، واستشهد بقول الله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ [النساء: 75]، وهذا يدل على أن حماية الضعفاء والمظلومين من أهم واجبات الإمام.
ولا يُشترط في الإمام العصمة من الذنوب، كما تدّعي بعض الفرق، بل يكفي أن يكون مسلمًا عادلًا يقيم الشرع ويؤدي الحقوق، ولا يُعرف في منهج أهل السنة وجود إمام معصوم أو غائب، كما هو الحال في الفكر الشيعي.
وإذا غاب الإمام أو تعذرت إقامة دولة الإسلام، فلا يأثم المسلمون، لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. ويقاس ذلك على بعض التكاليف الشرعية التي تسقط عند تعذر الشروط، كغسل اليد المبتورة، أو صلاة الجمعة في غياب الجماعة.
أما حديث: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» [رواه مسلم]، فمعناه -كما قال أبو حاتم وابن حجر- أن الميتة الجاهلية ليست كفرًا، بل تمثيل لحال أهل الجاهلية الذين لم يكن لهم نظام أو إمام، وكانوا يعيشون في فوضى.
قال الإمام ابن حبان في تفسير هذا الحديث: إنه يتعلق بمن لم يعتقد إمامة النبي ﷺ أو قدّم عليه غيره. أما المسلم في زمن غياب الإمام الشرعي فلا يدخل في هذا الوعيد، لأنه لم يقصّر في طاعة ولا خالف شرعًا.
وقال ابن حجر: الميتة الجاهلية لا تعني الكفر، بل المقصود أنه مات ميتة تشبه أهل الجاهلية في عدم التزامهم بالنظام السياسي الشرعي. وهذا يدل على أن الحديث لا يتناول كل من مات في عصر لا يوجد فيه إمام شرعي.
وقد رد أهل السنة على من استغل هذا الحديث لإثبات وجوب وجود إمام دائم حتى في حال غيابه، كما تفعل الشيعة الإمامية، فقالوا إن الإمام في الإسلام هو ولي الأمر الذي يقيم الشرع، ولا يُعرف عند أهل السنة مصطلح "إمام الزمان"، بل هذه بدعة لا أصل لها.
ودليل ذلك ما رواه البخاري عن النبي ﷺ: «من كره من أميره شيئًا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية»، فسمى النبي السلطان أميرًا، وهذا دليل على أن كل من تولى الحكم بإقامة الشرع فهو إمام تجب طاعته في المعروف.
وقد ثبت في الحديث عند مسلم أن النبي ﷺ أرشد حذيفة في زمن الفتن إلى لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم إمام، فليعتزل، ولو أن يعض على أصل شجرة. قال القاري: "أي: يبتعد عن الفرق الضالة، ويتمسك بطريق أهل السنة والجماعة".
ففي حال غياب الإمام، لا يُطلب من المسلم إلا أن يثبت على دينه، ويعتزل الفتن، ولا يبايع على غير حق، ولا يدخل في فرق ضالة. وهذا يدل على أن غياب الإمام لا يسقط الدين، ولا يوجب الكفر، بل يبقى المسلم على الحق متمسكًا بدينه.
ويُفهم من مجموع هذه النصوص أن الإمامة ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لإقامة الدين وتحقيق العدل، وأن وجود الإمام ليس شرطًا لصحة الدين، وإنما هو نعمة إذا تحققت وجب شكرها، وإذا فُقدت وجب الصبر والثبات.
كما أن الإمام عند أهل السنة لا يُعرف بالغيب ولا يُنتظر في السرداب، ولا يقوم مقام النبي في التشريع أو العصمة، بل هو بشر يجتهد، ويُصيب ويخطئ، ويُعزل إن ظلم، ويُطاع ما أطاع الله.
المصادر:
♦ القرآن الكريم
♦ صحيح البخاري
♦ صحيح مسلم
♦ الأحكام السلطانية للماوردي، ج1 ص26-27
♦ الإنصاف للباقلاني، ج1 ص4
♦ المحلى لابن حزم، ج1 ص45
♦ الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي، ج8 ص511
♦ صحيح ابن حبان والتعليقات الحسان للألباني، ج7 ص21
♦ فتح الباري لابن حجر، ج13 ص7
♦ مرقاة المفاتيح للقاري، ج8 ص3382
وبهذا يظهر أن الإمامة في الإسلام واجب إذا تيسر وجود الإمام، وهي نظام بشري يقيم الدين ويحقق العدل، لا عصمة فيه ولا غلو، كما يروّج بعض الفرق المنتسبة للإسلام. والواجب على المسلمين في كل زمان أن يتمسكوا بمنهج النبوة، ويجتمعوا على الحق، ويقيموا الدين في أنفسهم حتى يُيسر الله لهم إمامًا صالحًا، أو يمكن لدينه في الأرض.