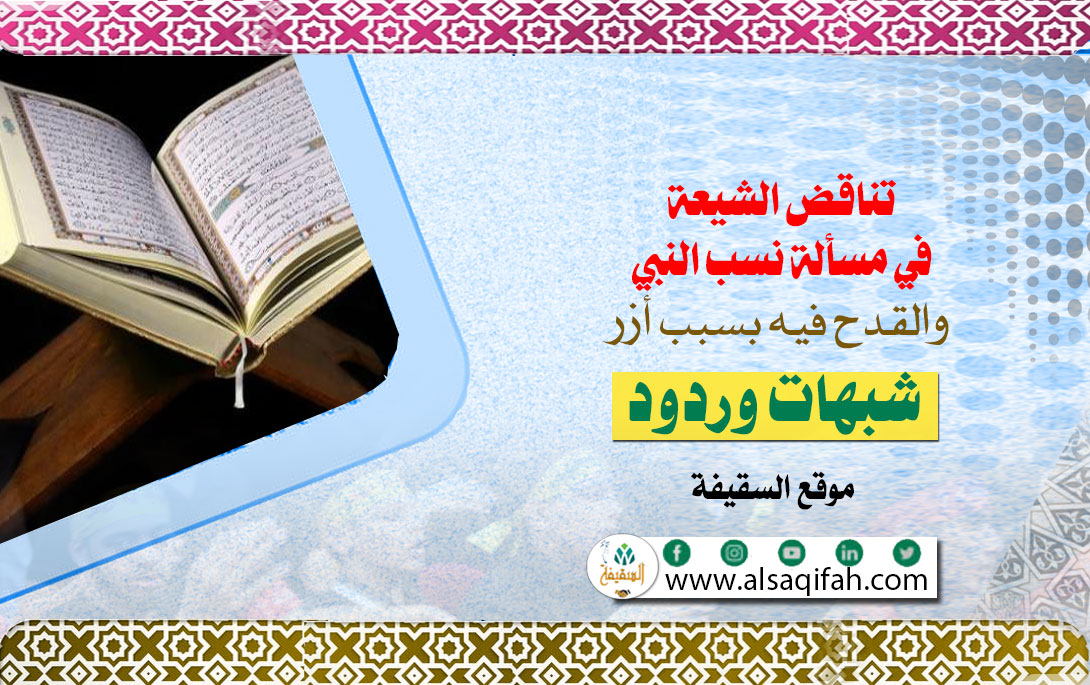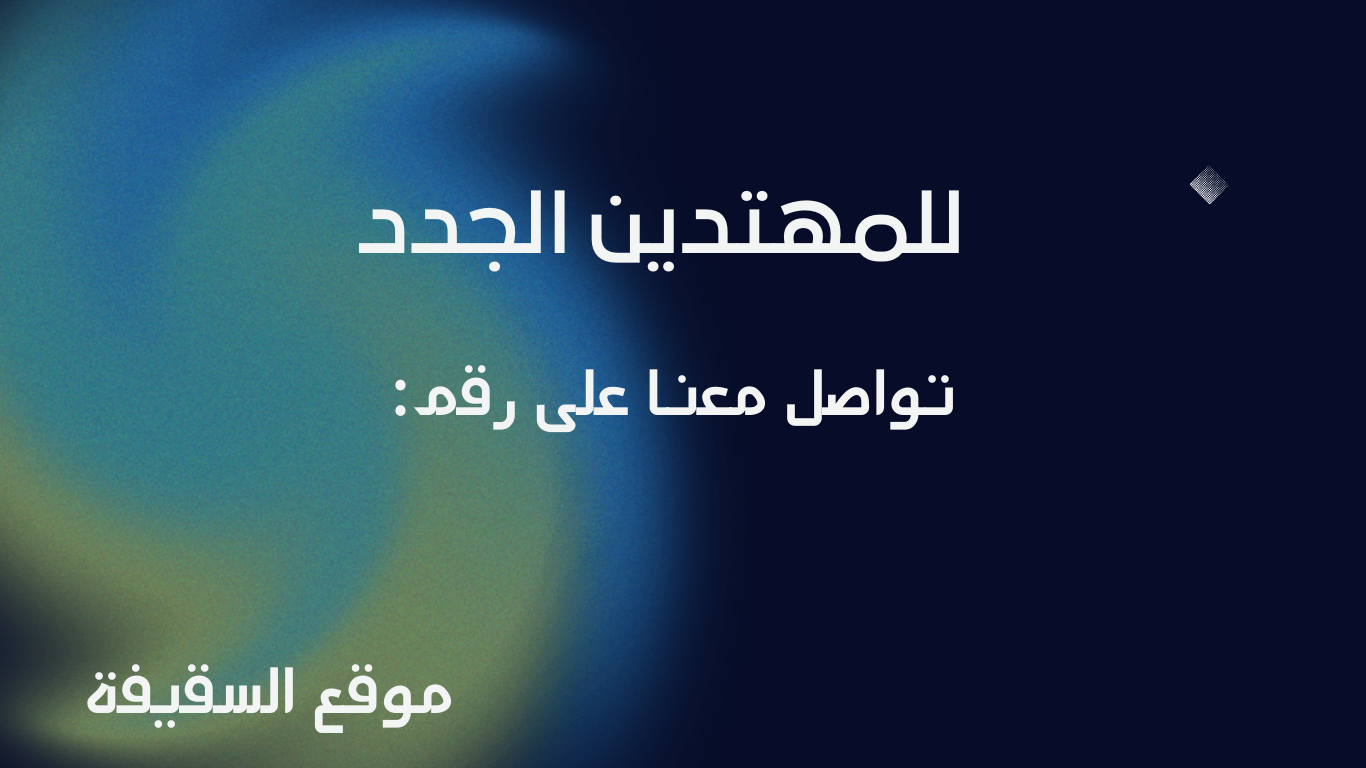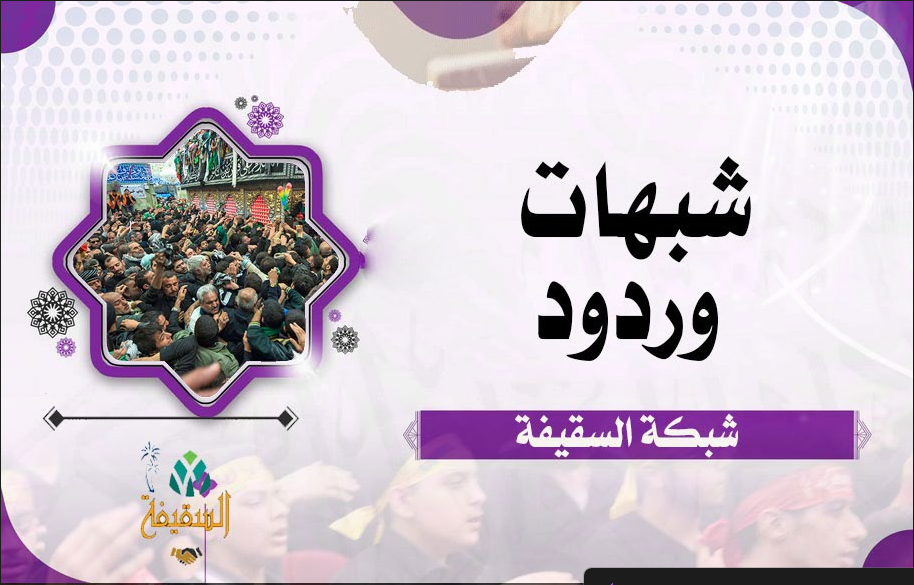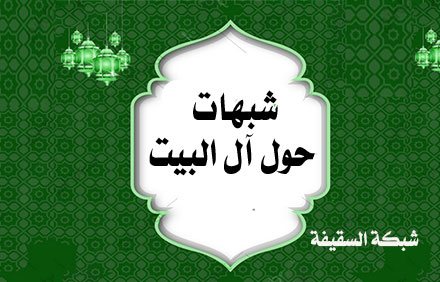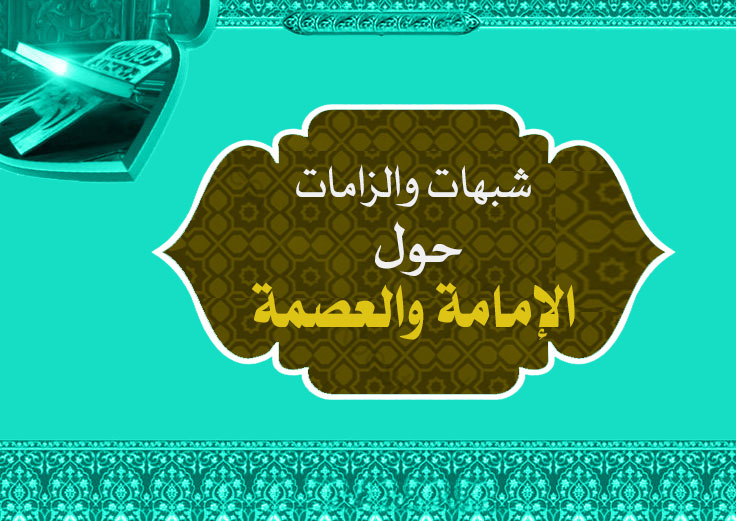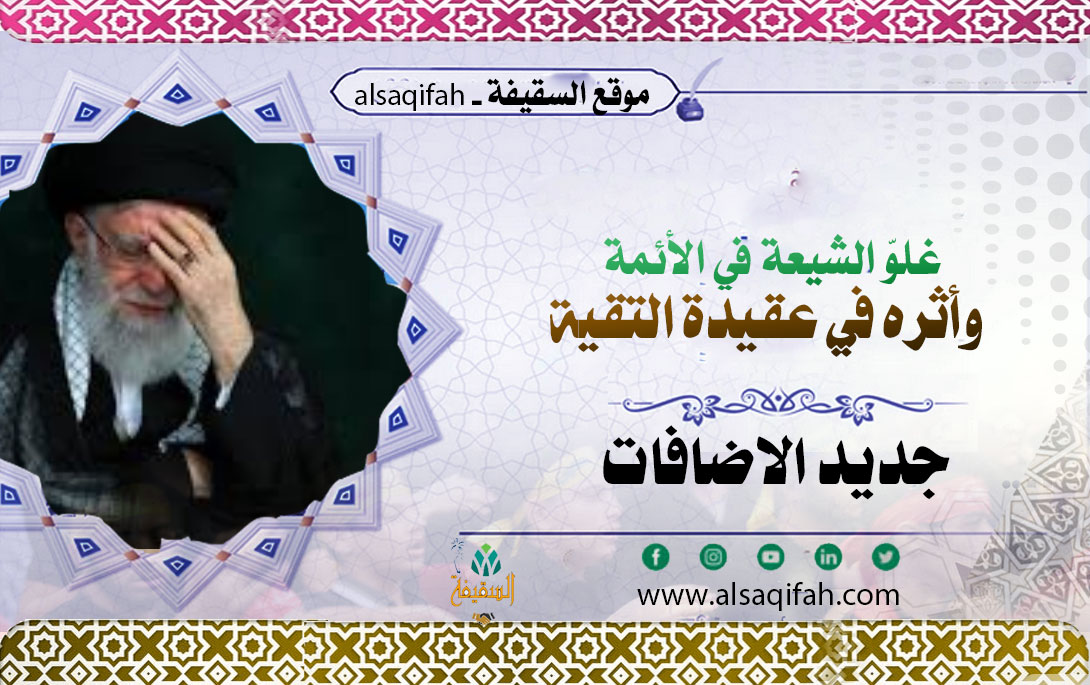من المسائل التي طالما استعملها الإمامية – وهي فرقة ضالّة عن منهج الإسلام الصحيح – للطعن في أهل السنة، مسألة القول في أبوي النبي ﷺ، حيث يُنكرون على أهل السنة قولهم إن أبويه لم يكونا مؤمنين.
غير أن هؤلاء يغفلون – أو يتغافلون – عن حقيقة راسخة في كتبهم هم، وهي إقرارهم بأن آزر والد إبراهيم الخليل عليه السلام كان مشركًا كافرًا، ومع ذلك فإن النبي ﷺ من نسل إبراهيم عليه السلام.
وهذا يعني أن الكفر في أحد الأجداد لا يقدح في مقام النبوة ولا في شرف النسب، وهو ما ينسف اعتراضهم من أصله.
فالقرآن الكريم نصّ بوضوح على كفر آزر، فقال الله تعالى:
◘ ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (سورة الأنعام: 74)
فآزر – بنصّ القرآن – كان كافرًا يعبد الأصنام، ومع ذلك اصطفى الله من نسله نبيَّه محمدًا ﷺ، فدلّ ذلك على أن النسب الشريف لا ينفع صاحبه ما لم يكن معه إيمان وعمل صالح.
وقد قرّر النبي ﷺ هذا الأصل العظيم بقوله:
«وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» [صحيح مسلم، ج4 ص2074]
فالعبرة ليست بالنسب ولا بالآباء، وإنما بما يقدّمه الإنسان من عمل صالح وتقوى لله سبحانه وتعالى.
المناقشة:
من خلال النظر في عقيدة الإمامية، نجد أنهم يعترفون صراحة في كتبهم بكفر آزر والد إبراهيم عليه السلام، ويوردون روايات مطوّلة تصف شركه وعبادته للأصنام، ومع ذلك لا يرون في ذلك ما يقدح في نبوة إبراهيم، ولا في شرف نسب النبي ﷺ الذي ينتسب إليه.
لكن حين يقول أهل السنة إن أبوي النبي ﷺ لم يكونا مؤمنين، بناءً على النصوص الصحيحة، يثورون ويجعلونها مطعنًا في العقيدة!
وهذا تناقض بيّن، لأن المبدأ واحد: أن الله تعالى لا يجازي الناس على أنسابهم، وإنما على أعمالهم.
قال تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ (سورة المؤمنون: 101)
فإذا كان إبراهيم عليه السلام من أبٍ كافرٍ ولم يضره ذلك شيئًا، فكيف يُجعل الإيمان بأبوي النبي شرطًا في تعظيمه أو في الإقرار بنبوّته؟!
الأدلة:
أولًا: من كتب أهل السنة
ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:
«وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»
وهذا نصّ قاطع يدلّ على أن التفاضل عند الله بالعمل لا بالنسب، وأن شرف الأصل لا ينفع صاحبه ما لم يُقِم الدين على وجهه.
ثانيًا: من كتب الإمامية أنفسهم
روى الشيخ الصدوق في معاني الأخبار باب (معنى العربية) ما نصّه:
«صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر يوم فتح مكة، فقال: أيها الناس إن الله تبارك وتعالى قد ذهب عنكم بنخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها، ألا إنكم من آدم وآدم من طين، وخير عباد الله عنده أتقاهم، إن العربية ليست بأبٍ ولا والدٍ ولكنها لسان ناطق، فمن قَصُر به عمله لم يبلغه رضوان الله حسبه...» (معاني الأخبار – الصدوق – ص207)
وهذا النصّ صريح في أن العمل الصالح هو المعيار، لا النسب ولا الأصل، وهو المعنى نفسه الذي قرّره الحديث الشريف في كتب أهل السنة.
ثالثًا: إقرارهم بكفر آزر والد إبراهيم عليه السلام
روى الكليني في الكافي ما نصّه:
«558 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن آزر أبا إبراهيم (عليه السلام) كان منجِّمًا لنمرود... وكان يصنع الأصنام بيده ويبيعها...»
(الكافي – الكليني – ج8 ص366–368)
|
مختارات من مقالات السقيفة |
|
شبهة آية (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك) على جواز التوسل بالنبي بعد وفاته؟ الشيعة تكفر آل البيت خارج الأئمة الاثني عشر |
وقال المجلسي في مرآة العقول عن الرواية: حَسَن (ج26 ص548)
فهذا نصٌّ من أهم كتبهم يقرّ صراحة بأن آزر كان كافرًا مشركًا، ومع ذلك يُسلِّمون بأن إبراهيم عليه السلام من صفوة أنبياء الله، وأن النبي ﷺ من نسله، دون أن يروا في ذلك حرجًا.
فما بالهم إذًا ينكرون على أهل السنة إذا قالوا إن أبوي النبي ﷺ لم يؤمنا؟!
الخاتمة:
يتّضح من مجموع الأدلة أن الإمامية متناقضون في هذا الباب؛ فقد أقرّوا في كتبهم بأن آزر – وهو جدّ النبي ﷺ من جهة إبراهيم – كان كافرًا، ومع ذلك لم يجعلوا ذلك طعنًا في مقام الأنبياء، بينما اعترضوا على أهل السنة في قولهم في أبوي النبي ﷺ، مع أن القاعدة واحدة والمبدأ واحد.
فالإيمان لا يُورَّث، والنسب لا يُغني عن العمل، وقد قال تعالى:
﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (سورة الحجرات: 13)
فمن أراد الكرامة عند الله فليُقدِّم التقوى والعمل الصالح، لا التفاخر بالنسب والآباء.
المصادر والمراجع:
1) القرآن الكريم – سورة الأنعام (74)، وسورة المؤمنون (101)، وسورة الحجرات (13).
2) صحيح مسلم، كتاب الذكر، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، ج4 ص2074.
3) معاني الأخبار – الشيخ الصدوق – ص207.
4) الكافي – محمد بن يعقوب الكليني – ج8 ص366–368.
5) مرآة العقول – العلامة المجلسي – ج26 ص548.